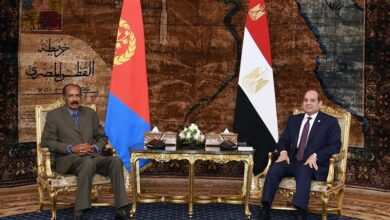سرّ التقدم ومفتاح الأزمات.. الخبز في الحضارة
عماد عنان
“يا رغيفنا، يا أب اللقمة الطيبة، لولاك ما طابت المائدة، يا خبزنا اليومي الكريم، كُن إنسانًا أكثر من الإنسان، وتكرّم على من حرمهم الدهر من لُقمتك، وعلى من اشتاقوا كثيرًا إلى طلعتِك وإطلالتك”.
بهذه الكلمات، ناجا شاعر المهجر اللبناني، رياض معلوف، رغيف الخبز معتبرًا أنه المخلّص الذي يقتتل الملايين في سبيل الحصول عليه يوميًا، وبمثابة الجائزة التي تتوج رؤوس الفائزين بالحصول عليه بعد ركض ربما يُهدرون في سبيله ماء الوجه، وأحيانًا دماء الجسد.
وخاطب مواطنه، الكاتب توفيق يوسف عواد، الرغيف ذاته الذي اختاره ليكون عنوانًا لروايته التي تدور أحداثها حول مجاعات الحرب العالمية الأولى، حيث قدم الرغيف هديةً لوالده الذي ضحى بسنوات عمره لأجل الحصول عليه وتوفيره لأبنائه، قائلًا: “إليك يا أبي أقدّم هذا الرغيف، فقد قدّمْت أنت إليّ في أيام الحرب الكبرى، وإلى إخوتي وأخواتي، أرغفةً سكبْتَ لها عَرَق جبينك ودمَ قلبك”.
ويقول الكاتب والشاعر السوري الراحل محمد الماغوط في إحدى قصائده الشهيرة متحدثًا عن الخبز أيضًا: “دعني أخبئ الخبز في لحمي كالدبابيس وأفتله كالشوارب فوق شفتي”. أما الشاعر اللبناني جبران خليل جبران، فيرى أن تقاسم الخبز تجسيد للإنسانية: “نصف الرغيف الذي لا تأكله يخص الشخص الآخر”. وبالمثل استخدمه الشاعر الفلسطيني محمود درويش بوصفه رمزًا للمحبة والحنين إلى والدته، عندما قال: “أحن إلى خبز أمي، وقهوة أمي، ولمسةِ أمي”، كما كان جزءًا من عنوان أحد كتب غادة السمان “الرغيف ينبض كالقلب”.
وشغل الخبز أيضًا مساحة واسعة في الأدب العالمي، الذي يحضر فيه بوصفه لاعبًا مؤثرًا في الحياة اليومية، مثل “بائعة الخبز” للفرنسي كزافييه دومونتبان، و”خبز العائلة” لمواطنه جول كلود رونار، فيما وصفه بول كلوديل بـ”الخبز القاسي”، واتخذه الأدب والناشط السياسي الروسي مكسيم غوركي عنوانًا لسيرته الذاتية.
في الثقافة الشعبية العربية، يطلقون على الخبز “العيش”، وأحيانًا “النعمة”. تُلخص التسمية الأولى اعتقاد الناس بأن الخبز هو العيش والحياة، وأنه في غيابه قد يجد الملايين أنفسهم تحت رحمة الجوع. أما الثانية، فتشير إلى أنه هبة من الله عز وجل ومكرمة إنسانية غالية يُنعم الإنسان به، ويُذّل بدونه.

أكثر من ذلك، تُشن الحروب بسببه وتندلع لأجله ثورات تسقط أنظمة وحكومات. في سبيله يُضحى بالغالي والنفيس، وتُراق على عتباته والدماء، وتتناثر الأشلاء، وتُهان الكرامة والكبرياء. إنه شعار التواقين إلى الحرية والباحثين عن الكرامة والراغبين في الحياة. وكان ثالث الشعارات الخالدة “عيش، حرية، كرامة إنسانية”. كما أنه المُقدّم على كل المشاعر والاعتبارات. وكما يقولون: “عض قلبي ولا تعض رغيفي”.
مُخطئ من يظن أن الخبز مجرد كسرة يسد بها الإنسان جوعه، أو يُسكت بها معدته، إذ لم تقم الحضارات إلا بفضله، ولم يقض المرء عمره في سبيل الحصول على شيء أكثر من الحصول عليه، ولا بُنيت أمم وهُدمت أخرى إلا به. فما هي قصة هذا المُخلّص الذي تحول مع مرور الوقت إلى حلم وغاية لسد رمق 2.3 مليار جائع على مستوى العالم، وأكثر من 69 مليون في العالم العربي؟
التاريخ العريق للخبز.. الأردن موطن أقدم رغيف في العالم
في 16 تموز/يوليو عام 2018، نشرت دورية “Proceedings of the National Academy of Sciences”، الصادرة عن جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، دراسة للباحثين آمايا اوتايجي، ولارا جونزاليس، ومونيكا رامسي، وتوبياس ريشتر؛ توصلوا من خلالها إلى أن أقدم مكان عثر فيه على بقايا خبز في العالم، كان في منطقة بالصحراء السوداء شمال شرق الأردن، حيث عُثر على بقايا متفحمة لخبز أُعد من قِبل مجموعة من الصيادين في هذا المكان قبل 14.500 عام.
توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد قيامهم بتحليل مكونات 24 مكانًا، تضمن بقايا طعام مدفونة. وبحسب الدراسة، فإن الخبز الذي عُثر على بقاياه هو من النوع المسطح الذي صُنع من حبوب الشعير أو الشوفان أو القمح، ومن درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي، والتي يبدو أنه جرى طحنها هي الأخرى إلى دقيق، وقد طُهي في موقد حجري إبان حضارة تعرف بـ”الحضارة النطوفية” (تنتمي إلى العصر الحجري القديم في الشرق الأدنى من 8 – 10 ألاف عام قبل الميلاد).
أثار هذا الاكتشاف الاستثنائي جدلًا واسع النطاق، إذ هزّ العديد من المعتقدات العلمية القديمة التي ترسخت في الأذهان لعقود طويلة، وعلى رأسها تلك التي تفيد بأن الخبز ظهر بعد الزراعة بوصفه أحد مخرجاتها. فقد أظهرت النتائج أن الخبز أقدم من الزراعة بأربعة آلاف عام، الأمر الذي يعيد ترتيب قائمة الحواضر التي احتضنت سلاسل الغذاء في العالم. هذا الاكتشاف يسلط الضوء على دور المنطقة العربية التي تفرض نفسها في مقدمة تلك القائمة، إذ يعد شهادة جديدة في حق الحضارة العربية وجذورها الضاربة في أعماق التاريخ.
أشارت الدراسة أيضًا إلى ضرورة البحث عن العلاقة بين نشأة الزراعة بوصفها سلوكًا إنسانيًا، وإنتاج الخبز. ولفتت إلى أن الخبز المكتشف، والذي نجح في أن يكون غذاءً مستدامًا للصيادين وسكان شمال شرق الأردن آنذاك، ربما أوجد حافزًا لدى الناس في ذلك الوقت للعمل في الزراعة بهدف توفير الحبوب التي تدخل في صناعة الخبز.
صناعة الخبز: من العصيدة إلى الرغيف
مرت صناعة الخبز تاريخيًا، منذ اكتشاف أقدم أثر له في العالم، قبل حوالي 14.500 عامًا في الأردن، بالعديد من المحطات التي شهدت تطورًا زمنيًا تسلسليًا في تلك الصناعة، شكلًا ومضمونًا، أبرزها رغيف العصيدة.
عرف الإنسان الخبز باعتباره سلوكًا اقتصاديًا معيشيًا منذ عام 8000 قبل الميلاد، حين بدأ يدرك أهمية الحبوب الزراعية، مثل القمح والشعير وغيرهما، إذ كان قبل ذلك التاريخ يتعامل مع هذا الغذاء بطريقة عشوائية غير ممنهجة، وهو ما دفعه لاحقًا إلى الاهتمام بالزراعة لأنها المورد الأهم لتوفير هذا النوع من الغذاء.
كان الخبز في ذلك الوقت يتخذ شكل “العصيدة”، إذ تُمزج الحبوب المبللة وتُطحن بواسطة أدوات خشنة كالأحجار وغيرها، نظرًا لعدم القدرة على تناولها بشكلها الأولى الصلب. ومع مرور بعض الوقت، تصبح متماسكة نسبيًا، فكان البعض يتناولها كـ”عجينة”، أو تُعرّض لدرجة حرارة مرتفعة، قد تكون حرارة الشمس عن طريق الصدفة أو للهيب النار، حتى تُطهى ثم تؤكل.
وكان الخبز لا يحتوي بدايةً على الخميرة، وتشير الدراسات إلى أن الخبز صنُع في البداية وسط آسيا، وعن طريق مصر وبلاد ما بين النهرين أيضًا. وبفضل العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا، انتقل إلى البحر الأبيض المتوسط وبلدان شمال إفريقيا.
الخبز المُخمر
منح النيل مصر فرصة اكتشاف الزراعة وممارستها واستنبات الحبوب، وكان على رأسها القمح والشعير. كما كان الفيضان الذي يغمر النهر في شهر تموز/يوليو من كل عام سببًا رئيسيًا في تميز مصر في زراعة القمح، الذي تصدر حبوب صناعة الخبز فيما بعد نظرًا لمكوناته المتميزة، خاصةً امتلاكه عنصر الغلوتين المسؤول الأبرز عن تخمير الخبز.
من هنا عرفت مصر الخبز الذي تُضاف إليه الخميرة، ويُنسب للمصريين الفضل في أنهم أول شعوب الأرض التي قامت بالمزج بين البذور من نباتات مختلفة مضافًا إليها الخميرة لصناعة خبز حلو المذاق، طيب الرائحة، وخفيف الوزن. وتميزوا كذلك في نصب الأفران التي صُنعت أول الأمر من الطوب وكانت تتكون من جزئين، الأول في الأسفل، وهو المسؤول عن إشعال النيران من خلال إضافة مكونات معينة، بينما الثاني في الأعلى، حيث كان يوضع العجين.
خبز الشعير وظهور مهنة الخباز
عرف العالم في العصور الوسطى ( القرن الخامس وحتى الخامس عشر) الخبز المصنوع من الشعير، وكانت أوروبا في ذلك الوقت من أكثر بقاع العالم زراعةً لهذا المحصول، الذي كانوا يضيفون إليه الشوفان لصناعة خبز عالي الجودة نسبيًا، مع استخدام الخميرة بهدف منحه مذاقًا ورائحة جيدة. وفي المقابل، اعتمد الأميركيون على الذرة في صناعة خبزهم.
تميز الأوروبيون باستخدام الخميرة المصنوعة من العجة في ذلك الوقت، حيث كانوا يصنعون أنواعًا مختلفة من الخبز، مخمور وغير مخمور. ومع مرور الوقت، تحولت عملية الخَبْزْ إلى حرفة لها أصولها، وبدأت تظهر عمليًا مهنة “الخبّاز” التي كان لها مكانة مجتمعية بارزة، ورافقتها طفرة كبيرة في صناعة الأفران بمختلف أشكالها.
وكان الخبازون في أوروبا، كغيرهم من أبناء المهن الأخرى، محكومون بقانون عمل يمنع مزاولة مهنتهم في الليل. لكن منذ القرن السادس، وفي ظل الاحتياج الكبير للخبز الذي بات الغذاء الرئيسي في القارة، تم إعفاؤهم من تطبيق هذا القانون والسماح لهم بالعمل على مدار اليوم لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخبز مع تزايد أعداد السكان.
الخبز البسكويت
شهدت صناعة الخبز تطورًا كبيرًا خلال عصر النهضة، حيث بدأت تظهر فيه أنواع جديدة من الخبز الخفيف، يُعرف اليوم بـ”البسكويت”، التي تعود إلى عام 1915، إذ بدأت عواصم أوروبا تتعامل مع الخبز بوصفه علمًا يجب تطويره ودراسته بشكل منهجي مكثف، فجرى افتتاح أول مدرسة لتعليم إعداد الخبز في 8 حزيران/يونيو 1780 في فرنسا.

في تلك المدرسة، تم تجريب العديد من المحاصيل والحبوب لإنتاج خبز مميز، ومن بينها استخدام دقيق البطاطس الذي كانوا يعتقدون بأنه قد يحل مكان كل من القمح والشعير. لكن مع مرور الوقت، اكتشفوا أنه يفتقد إلى جودة وإمكانيات الخبز المصنوع منهما، فتراجعوا عن اعتماده كعنصر غذائي أساسي في القارة. لكن، في المقابل، اعتُمدت صناعة الحلوى المنبثقة عن الخبز بشكل أساسي بعد إضافة السكر والزبدة مع بعد الثورة الصناعية.
الفينو والفرنساوي
مع التقدم العلمي الذي انطلق منذ نهايات الثورة الصناعية، شهدت صناعة صناعة المخبوزات تطورات وابتكارات عدة، حيث ظهرت أنواع جديدة مثل خبز فيينا المعروف باسم “الخبز الفينو”، الذي استخدم فيه بخار الماء لأول مرة. ثم خبز الباغيت الذي يُعرف باسم “الخبز الفرنسي”، والذي يتميز بجودته من حيث الشكل والطعم.
وفي عام 1927، التقى علماء ومهندسون من 15 دولة أوروبية، متخصصون في علوم التغذية، في العاصمة التشيكية براغ؛ لمناقشة كل المشاكل المتعلقة بصناعة الخبز وسبل تطويره، واستقروا على أن يُقعد هذا الاجتماع بشكل دوري، وذلك تحت اسم “المؤتمر العلمي للحبوب والخبز”، برعاية الجمعية الدولية للحبوب الكيميائية، وكان من بين مخرجات المؤتمر إضافة الفيتامينات ومضادات التأكسد والحديد إلى لخبز، من أجل تحسين الغذاء.
مع مرور الوقت والاكتشافات العلمية المتلاحقة، واستنادًا إلى مخرجات التجارب البحثية، تم تقليص استخدام أنواع معينة من الحبوب التي كانت شريكا أساسيًا في صناعة الخبز، مثل الذرة والشعير، فيما بقى القمح المحصول الرئيسي والأساسي لصناعة العيش الذي يعتمد عليه المليارات من سكان الأرض، ليتحول بعد ذلك إلى سلعة استراتيجية ذات بعد قومي، قادرة على منح السيادة والاستقلالية لدول وتجريدها من دول أخرى.
القمح: سلاح استراتيجي؟
لم يعد القمح مجرد محصول أو سلعة مثل بقية المنتوجات الزراعية التقليدية، بل أصبح أهمها وأكثرها نفوذًا، إذ يحتاج إليه أكثر من 2 مليار جائع حول العالم. أما في المنطقة العربية، فإن الأمر أكثر قسوة، إذ يعتمد الغالبية العظمى من أبناء المنطقة على الخبز بوصفه وجبة رئيسية دائمة في ظل ما تعاني منه منظومة الأمن الغذائي من أزمات متفاقمة.
يوفر الخبز نحو 20% من احتياجات الفرد اليومية من البروتين والسعرات الحرارية الغذائية، ويحتوي أيضًا على فيتامين “ب” والألياف الغذائية والبروتين. ولذلك، يمتلك القمح سلطة مطلقة على نحو 69 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم العربي، بحسب الأرقام الرسمية، رغم أن الواقع يشير إلى أعداد تفوق ذلك بكثير.
كما كشف التقرير الصادر عن “المنظمة العربية للتنمية الزراعية”، والمعنون بـ“أوضاع الأمن الغذائي العربي 2022”، عن الفجوة الكبيرة بين نسبة السكان العرب من إجمالي سكان العالم، ومعدل استهلاكهم من صادرات الحبوب العالمية. وتكشف هذه الفجوة حجم الكارثة التي يواجهها أبناء المنطقة، والتي تجعل قرارهم السيادي الوطني مرهونًا لجهات أخرى تتحكم في غذائهم.
يقول التقرير إن السكان العرب، مجتمعين، يشكلون نحو 5% فقط من سكان العالم. ورغم ذلك، يستهلكون أكثر من 25% من صادرات الحبوب في العالم، الأمر الذي يخلق فجوة قدرها 400% تقريبًا، عدا عن تراجع معدلات الاكتفاء الذاتي عربيًا من إنتاج المحاصيل الداخلة في صناعة الخبز، وهنا تكمن الكارثة.
تشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أن الدول العربية تستورد حوالي 57% من احتياجاتها من القمح، و66% من احتياجاتها من الذرة الشامية، و65% من احتياجاتها من السكر؛ من خارج الوطن العربي، ما يعني أن أكثر من نصف استهلاك العرب من الخبز يأتي من مصادر خارجية، وتتحكم فيه قوى غير عربية.
ووفق منظمة “وورلد توب إكسبورت” المعنية بحركة التجارة الدولية، هناك 3 دول عربية ضمن أكبر 10 دول مستوردة للقمح في العالم، وهي: مصر (تحتل المرتبة الثانية، حيث تستورد ما قيمته 3.8 مليارات دولار، تشكل نسبة 5.3% من إجمالي القمح المستورد عالميًا)، والجزائر (في المرتبة السادسة، تستورد بقيمة 2.7 مليار دولار، ما نسبته 3.7% من إجمالي القمح المستورد)، والمغرب (في المرتبة الثامنة، تستورد بقيمة 2.56 مليار دولار، ما نسبته 3.5% من القمح المستورد عالميًا).
ويواصل إنتاج الدول العربية من الحبوب (القمح والذرة والشعير) تراجعه عامًا بعد عام، ما يُعد مؤشرًا خطيرًا يعكس حجم الأزمة، خاصةً إذا ما وضعنا في الاعتبار الزيادة السنوية الكبيرة في عدد السكان. فقد سجّل إنتاج الحبوب في المنطقة العربية لعام 2022 حوالي 49.5 مليون طن، متراجعًا بنسبة 9.1% مقارنةً بإنتاج عام 2021. وقد انخفض هذا الرقم بنسبة 9.9%، وفق التقرير، عن متوسط إنتاج الحبوب خلال الفترة من 2016 – 2021.
ويتصدر القمح قائمة إنتاج الوطن العربي من الحبوب، حيث يشكل نسبة 38.3% من مساحة محاصيل الحبوب، ونحو 49.3% من حجم الإنتاج في المنطقة. ويتركز نحو 92% من إنتاج الحبوب في العالم العربي في 6 دول: مصر (9.8 مليون طن، بنسبة 40% من الإجمالي)، والجزائر (15%)، والعراق (12%)، والمغرب (11%)، وسوريا (8%)، وتونس (5%).
ونُلاحظ عند مقارنة أرقام 2022 مع متوسط الفترة من 2016 – 2021، أن هناك تراجعًا واضحًا في معدلات الإنتاج، إذ انخفض إنتاج القمح في المتوسط بنسبة 6.6% عما كان عليه في تلك الفترة. وبالمقارنة مع عام 2021، فقط فقد تراجع بنسبة 12.1%، وهي نسبة كبيرة تنذر بأزمة حقيقية إذا ما استمرت معدلات التراجع على هذه الشاكلة.
وبلغت الأراضي المزروعة في الوطن العربي حاليًا نحو 72.8 مليون هكتار، بما نسبته 5.4% من مساحة الدول العربية، وهو جزء من الـ38.5% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة العربية. ويبلغ نصيب الفرد من تلك الأرض نحو 0.14 هكتار مقارنةً بالمتوسط العالمي، البالغ 0.18 هكتار للفرد.
نتيجة لهذه المعطيات، شهدت الدول العربية زيادة مقلقة في الفجوة الغذائية، إذ تشير معظم التقديرات إلى ارتفاعها من 34 مليار دولار سنويًا في 2012، إلى نحو 60 مليار بحلول 2030، تمثل الحبوب أكثر من نصفها وفق المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي دقت ناقوس الخطر إزاء ما تحمله من الأرقام من تهديدات ومخاطر بشأن مستقبل المنطقة وشعوبها.
متى يتحقق الاكتفاء الذاتي من القمح؟
مع كل أزمة غذائية يتعرض لها العالم، لأي سبب من الأسباب، يكون السؤال الأكثر إلحاحًا على ألسنة 430 مليون عربي: متى نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، خاصةً كونه السلعة الأهم استراتيجيًا وغذائيًا على النطاق العربي؟ سؤال حرج رغم مشروعيته، وغامض رغم وضوحه، وصعب رغم سلاسته.
ومع تصاعد الاضطرابات والتهديدات التي تزلزل حركة التجارة العالمية وتقلب الطاولة على خارطة الاقتصاد بين الحين والأخر، لم يعد الاكتفاء الذاتي من الغذاء مسألة نقاشية من باب الرفاهية فحسب، فكما تقول المأثورة الشعبية : “من لا يملك غذاءه وسلاحه فلا يملك قراره”.
إذن، الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، خاصةً حين يكون أكثر من نصف احتياجات العرب من الخبز بأيدي قوى أخرى، بعضها يمتلك أجندات سياسية في المنطقة، ما يعني أن هذا المحصول تحول بشكل ضمني إلى سلاح وأداة ضغط قوية تهدد سيادة الدول وتقوض استقلالها وقرارها السياسي، بل وقد ترغمها على الانصياع للإملاءات وشروط في مقابل منحها هذا المحصول.
يشير الخبيران الاقتصاديان في إدارة الموارد المائية بالبنك الدولي، أندرس جاجيرسكوج وأشوك سوان، في مقال لهما، إلى أن الأمن الغذائي سيكون على رأس التهديدات الأمنية الناشئة التي تحدق بالشرق الأوسط والمنطقة العربية التي تستورد أكثر من 50% من السعرات الحرارية التي تستهلكها، وهو ما يرهن قرارها بيد غيرها.
ولفت الخبيران إلى أن المخاطر هنا ليست حصرية على البلدان النامية والفقيرة، بل تواجه حتى الدول الغنية، في إشارة إلى بلدان الخليج النفطية، إذ إن تلك البلدان تعتمد في تلبية احتياجاتها الغذائية على الأسواق العالمية الخارجية، وهو ما يهدد سيادتها، لا سيما أوقات الأزمات التي تواجه منظومة التجارة العالمية بين الحين والآخر، وهو ما اضطر بعض الدول إلى اللجوء لتبني استراتيجية تأجير وشراء الأراضي الزراعية خارج حدودها لتعزيز أمنها الغذائي في أوقات الاضطرابات.
وهناك في عالمنا العربي تجربتان ناجحتان نسبيًا في تحقيق تجربة الاكتفاء الذاتي من القمح هما سوريا والعراق. بالنسبة إلى سوريا، فقد كانت الدولة العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي من القمح قبل 2011، حيث كانت تزرع قرابة 1.7 مليون هكتار، بمتوسط إنتاج وصل إلى 4 ملايين طن سنويًا. وقد وصل الإنتاج إلى ذروته عام 2006، حين وصل إلى 4.9 مليون طن، مما سمح للحكومة آنذاك بتصدير الفائض، إذ كان إجمالي الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 2.5 مليون طن.
لكن نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد، سواء سياسية أو مناخية، تراجع الإنتاج من القمح بنسبة بلغت 70% تقريبًا، حيث وصل في 2024 إلى حوالي 1.5 مليون طن، ما دفع الحكومة للتوجه نحو الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تبلغ قرابة مليون طن تقريبًا.
أما العراق، فتعد تجربته الأنجح على الإطلاق فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي من القمح عربيًا، حيث نجح العراقيون، رغم الاضطرابات الأمنية التي تعيشها البلاد، في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حيث بلغ إنتاجه عام 2019 قرابة 4.7 مليون طن، بينما يستهلك العراقيون 4.2 مليون طن سنويًا. وتشير التقديرات إلى احتمالية أن يصل إلى 7 مليون طن في 2024.

ثمة تساؤل يفرض نفسه هنا: هل البيئة الزراعية في المنطقة العربية غير صالحة لزراعة كميات كبيرة من القمح؟ بالإجابة على هذا السؤال، كشف خبراء الزراعة أن منطقة الشرق الأوسط، وآسيا عمومًا، هي البيئة المثالية لزراعة محصول القمح، سواء من حيث درجات الحرارة المطلوبة (يحتاج القمح إلى درجة حرارة تتأرجح بين 22 – 27 درجة مئوية، قد تصل إلى 33 درجة في مرحلة النضج) أو توفر المياه (يحتاج القمح إلى معدل مياه يتراوح بين 375 – 875 ملم من الأمطار السنوية تقريبًا)، أو جودة التربة وخصوبتها وقدرتها على الصرف الجيد. وتشير خارطة إنتاج القمح العالمية إلى أن أكثر المناطق التي ينمو فيها بصورة جيدة هي تلك التي تتمتع برطوبة نسبية مثل مناخ البحر المتوسط، والأخرى ذات الشتاء المتوسط كما في جنوب إفريقيا وأستراليا وجنوب أوروبا.
إذًا ما هي الأسباب التي تعيق العرب عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟ هناك أولًا الإرادة السياسية. ففي لقاء جمعني عام 2005 مع عالم الهندسة الوراثية المصري الشهير الدكتور أحمد مستجير (1934-2006)، كان محور الحديث حول أسباب عدم اكتفاء مصر ذاتيًا من القمح، والارتهان للقرار الأميركي على اعتبار أن واشنطن كانت تزوّد مصر بشحنات من القمح كل أسبوعين، لضمان استمرارية الحاجة إليها في هذه السلعة الاستراتيجية، التي تمثل عصب الحياة للملايين من المصريين.
قال العالم المصري في حينها إنه كان قد تقدم، قبل سنوات، ببحث لوزارة الزراعة المصرية عن اكتشاف هجين من القمح والأرز يمكن زراعته بأقل قدر ممكن من المياه، كما أنه أجرى اختبارات ناجحة على زراعته في الصحراء وعلى شواطئ الترع والمصارف وكذلك الأنهار، لكنه فوجئ بتجميد البحث وتجاهله، رغم أن الدولة كانت في ذلك الوقت تتكلف الملايين من الدولارات من أجل استيراده من الخارج.
أكد مستجير أن غياب الإرادة السياسية للدولة هي السبب الرئيسي لعدم الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، إذ إنه لو كانت هناك إرادة لوضعت الدولة خططها الاستراتيجية لذلك ولنجحت في هذا الأمر، خاصةً في ظل توافر كافة المقومات في المنطقة العربية.
لكن الضغوط الفوقية الممارسة على الحكومات من أباطرة القمح في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين، السبب الأهم لبقاء مصر، وغيرها، متأخرة وفي حاجة إلى الدول الخارجية لسد الأمعاء المصرية/العربية الخاوية، بعدما حولت تلك السلعة إلى سلاح ضغط وابتزاز.
وإلى جانب الإرادة السياسية، هناك أيضًا السياسات الخاطئة التي تعد من الأسباب المهمة التي تعيق زراعة الكميات المطلوبة من الأراضي الزراعية بالقمح والحبوب. فهذه السياسات الخاطئة التي تتبناها بعض الحكومات تمنح الأولوية للتصدير، حيث تميل إلى زراعة المحاصيل المطلوبة للتصدير فقط لكونه يدر أموالًا سريعة، مثل الموالح والخضروات، وهو ما يأتي على حساب المساحة المزروعة بالقمح والأرز والذرة.
وتعد العوامل البيئية والمناخية من أبرز التحديات التي تعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصةً التصحر والجفاف والفيضانات، وهو ما حدث في مع سوريا والمغرب لعدة سنوات. كما تشير التقديرات إلى أن الجفاف تسبب بأضرار بالغة لأكثر من 44 مليون شخص بالمنطقة العربية خلال الفترة بين عامَي 1990 – 2019.
وهناك الصراعات والاضطرابات السياسية التي تشهدها دول المنطقة، التي لعبت دورًا كبيرًا في تقليل مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب، مثل ما حدث في اليمن وليبيا والسودان وسوريا. ويعتبر الخبراء أن آليات التخزين الخاطئة تعد سببًا كبيرًا في تلك الأزمة، مستشهدين بما حدث مع مصر خلال عام 2015، حيث خسرت الدولة 4 ملايين طن من القمح، بما نسبته 40% من إجمالي الإنتاج بسبب سوء التخزين.
*ميغازين